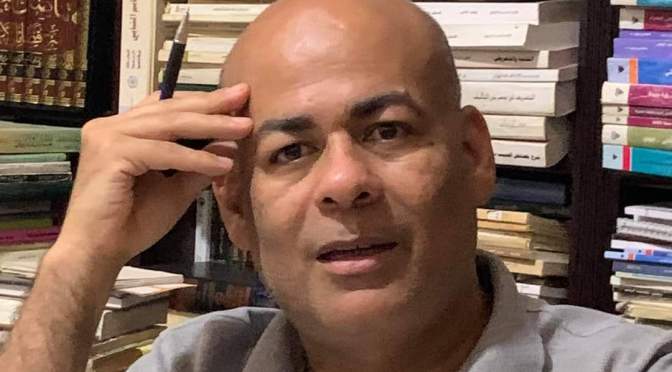قراء نقدية: سيد الوكيل
عادة ما تكون البدايات الإبداعية مع القصة، فيبدو هذا نوعاً من اختبار الذات الساردة، وقدرتها على التناغم مع حدس اللحظة الملهمة، تلك التي يشبهها ( جاستون باشلار) بأحلام اليقظة، حيث تلوح فكرةُ أو مشهدُ في لحظة مراوغة بين الوعي واللاوعي. هذا الأخير/ اللاوعي، هو ما يمنح القصة طاقتها الجمالية عبر الأخيلة التي تسكن طفولتنا الأولى وتظل تداعب مشاعرنا وتراودنا في أحلام نومنا ويقظتنا. أما الوعي فهو القارئ الضمني الساكن في الأعماق بوصفه مجموعة من الخبرات والمعارف الثقافية والمهارات التعبيرية.

في هذا السياق، أذكر (المكحلة) وهي المجموعة القصصية الأولى للكاتبة القطرية (هدى النعيمي) وهو ما أدهشني، فرحت أسأل نفسي: كيف للكتابة الأولى أن تحظى بهذا القدر من النضج؟. فمن طبيعة التجارب الأولى أنها تحظى ببعض الاضطراب الذي ينشأ عادة من رغبة ملحة في طرح كل الإمكانات الفنية في عمل واحد.

المكحلة.. تحفل بصيغ أسلوبية متعددة، تكشف عن جهد الكاتبة – من خلال التجريب – في البحث عن خصوصيتها وهذه إشارة إلى ما تمتلكه «هدى النعيمي » من وعي بطبيعة القص ومراحل تطوره، ويتجلى في الميل إلى التجريب، حيث تحاول الانفلات من آليات السرد التقليدي وذلك من خلال كسر تراتب الإيقاع السردي الممثل في الزمن. يحتاج هذا لعدة حيل تقنية، من أهمها تقسيم النصوص وإخضاعها للحظات قص متباينة، تكشف عن طبيعة البناء الأسلوبي، وتحقق دلالتها من خلال مفردات تنصت بدقة إلى الإيقاع النفسي للشخصيات، هذا الإيقاع الذي يتجلى في صورة صراع دائم بين رغبات الذات وسلطة الآخر. تعبّر المسافة بين الذات والآخر -قرباً وبعداً – عن عمق الاغتراب الذي تعانيه معظم شخصيات المجموعة، والتي تبدو عادة متمثلة في ضمير المتكلم حيث يتيح هذا الضمير الكشف عن مستويات الشعور للذات الساردة، لتنقل النص من المستوى الحكائي المباشر إلى المستوى المشاعري.
ولقد جاء اختيار قصة ( أشياء) لتكون أولى قصص المجموعة، اختياراً موفقاً حيث يتضح في هذه القصة قدرة الكاتبة على خلق بناء سري متميز، مستفيدة من ضمير المتكلم لتصل بالنص – ولا سيما في بدايته – إلى لغة شعرية خافتة. يتكون البناء السردي لقصة (أشياء) من خمس علامات لكل علامة عنوان مختلف، هي على الترتيب:( رائحة – ابيض -اسود – احمر – اصفر) وحين نقول إنها خمس علامات، فإننا نعني بهذا أن نشير إلى الخاصية الفريدة للتقنية التي جمعت بين الاختلاف والتوحد، فعلى حين تستقل كل علامة بحدث خاص، فإنها في نفس الوقت تمهد لحدث العلامة التالية، وكأنما تمرر نفقا سريا، يجعل من العلامات الخمس نسيجاً واحداً لتؤكد وحدة المعنى ودقة البناء الدلالي العام للنص كله. وما يعطينا هذا الانطباع بوحدة البناء السردي، هو موقف الذات الساردة من العالم، الذي يظل واحداً في كل النصوص (العلامات) باستثناء العلامة الأولى التي جاءت كافتتاحية تشير فقط ولا تعين، مستعينة بلغة أكثر مراوغة واتساعاً من لغة القص وأكثر اقتراباً وتواشجاً مع لغة الشعر.
وهكذا تبدو اللغة في نص (رائحة) قادرة على حمل الإيقاع النفسي للذات الساردة، ربما تأتي هذه القدرة من استخدامها لأساليب المجاز اللغوي، واعتمادها كثيراً على الاستعارة، الأمر الذي يكاد يختفي في باقي حركات النص، حيث تفرض بنية السرد القائمة على الحدث لغة ذات مستوى حكائي ينمو بالحدث.
وعلى الرغم من ذلك فلغة الحكي هنا لا تتخلى عن طاقاتها الشعرية وتحقق ذلك لا من خلال الأساليب البلاغية فحسب، وإنما من خلال الإنصات الدقيق لحركة الشخصيات، مستفيدة من الطاقة البصرية للغة استفادة لافتة للانتباه. لهذا لم يكن من قبيل المصادفة إن تحمل الحركات الأربع . أسماء دالة على ألوان ترى بالعين، فيما تحمل الحركة الأولى التي اعتبرناها ذات أسلوبية مختلفة اسماً مختلفاً هو (رائحة) حيث لا شيء يثبت هنا للرصد والمشاهدة بقدر ما هو نوع من الاستشعار عن بعد، لكنه وطبيعة العالم هكذا مراوغة بين المجازي والحقيقي أو بين المتعين والخفي، يخلق نوعاً من المفارقة الحادة التي يقوم عليها النص.
فهذه المفارقة الواضحة بين الألوان والروائح أو بين المرئي واللامرئي، تؤكد قدرة الذات الساردة على الإنصات المرهف لإيقاع النص، وتكشف عن وعي الكاتبة بطبيعة اللغة من ناحية، وبطبيعة السرد القصصي من ناحية أخرى. لقد بدأ السرد في النص الأول (رائحة) بلا تعين حدثي فلا شيء يكون ممسوكاً. فالحدث يعلن عن نفسه فقط من رائحة القهوة التي تعبّق المكان، بل حتى لا يمكننا تحديد معالم المكان أو الزمان أو أي من الشخصيات،لتبدو لحظة ضبابية متشابكة. تقول: ( يعلو دوي صوته بداخلي – كدوي البحر تماماً، الكلمات عجينة هشة لا أفهمها – الدوي يزداد علواً، والعجينة تزداد هشاشة، وعيناي تبحثان عن نقطة تتعلقان بها).
هكذا تبدو العيون قلقة بالبحث عن العالم واكتشاف وجه الحياة الطويلة التي عاشها الزوجان بمجموعة من الأخطاء اليومية والبسيطة التي تبدأ منذ اللحظة الأولى في حياتهما، لكنها تستمر لتصبح ركاماً يستحيل الاستمرار معه.
ففي نص (ابيض) أولى حركات الألوان الأربعة، يثير ثوب الزفاف الأبيض تداعيات الليلة الأولى في حياة الزوجين إنها تبدو مفعمة بالانسجام العاطفي، محاطة بالرعاية الكاملة، غير أن ثمة خطأ واحد يقع فيه الزوج، حين تسمعه الزوجة – وهي في حمام صبيحة الزفاف – يحادث أمه في الهاتف ويؤكد لها أن ليلته مرت كما ينبغي، وربما يصف لها بعض التفاصيل الصغيرة الدالة على نجاح هذه الليلة، حينئذ تشعر الزوجة أن جزءً من أشيائها الخاصة ينتهك لصالح آخرين، وحين تعاتبه على ذلك يقول لها:
– لكنها أمي، فتقول هي: لكنها أشيائي.
وهكذا تمضي باقي العلامات في (أسود – أحمر – أصفر) لتبدأ بالمثير اللوني الذي يكون (الحناء – الدم -الذهب) على التوالي لتنتهي بنفس الجملة الاحتجاجية من الزوجة: لكنها أشيائي.
إن الأخطاء التي يقع فيها الزوج تبدو بسيطة، لكنها تبدو فادحة بالنسبة للزوجة، وهذه المفارقة بين وعي الزوجين بطبيعة الخطأ هي نفسها «خطأ تراجيدي» تقع فيه المؤسسة الاجتماعية الأكثر رسوخاً، وهي المؤسسة الزوجية، إذ أن هذه المؤسسة مازالت تنظر إلى المرأة باعتبارها كياناً ينبغي أن يذوب تماما لصالح المؤسسة، دون مراعاة لخصوصية وتفرد كل واحد من أفراد هذه المؤسسة، وهكذا يطرح النص مفهوماً للعلاقة الزوجية يأتي على عكس ما هو شائع من أن الزواج هو انتقال من الخاص والفردي، إلى العام الاجتماعي .
هكذا يبدو أن انتهاك خصوصية الإنسان هو في الحقيقة انتهاك لذاته، فالذات لا تتحقق ولا توجد بعيداً عن عالمها الخاص، إن انتهاك الخاص هو في الحقيقة بعثرة للذات، هذه البعثرة التي قد تؤدي إلى الضياع والتشذي.
ولهذا، فان الزوجة حين تُنتهك خصوصيتها، تبدأ في التفتت والاندياح لصالح معنى عام، لكنها لا تكون جزء من هذا العام، ولا تشارك فيه، ويأتي هذا المعنى في نهاية النص على لسان الزوجة حين: « تقول لكنها أشيائي الخاصة بي أنا فقط أريد أن امتلك أشيائي هذه، لا أريد من يبعثرها هنا وهناك، لا أريد من يقلل من قدسية أشيائي» وهكذا.. نحن أمام ذات تقاوم بعثرتها، تحاول امتلاك خصوصيتها التي تشكل وتعادل هويتها، ليبدو أن افتقاد الخصوصية يعادل افتقاد الهوية.
ومن هذا المنطلق تقدم (هدى النعيمي) نصاً آخر تتأكد فيه هذه الفكرة، فكرة الدفاع عن خصوصية الذات وحفظها من الضياع في الآخر، يأتي هذا في نص بعنوان (العيد). وإذا كان النص السابق يتحدث عن نوع من الهوية الاجتماعية، أي هوية الفرد داخل المجتمع، فان قصة (العيد) تصعدُ بالمشكلة إلى مفهوم الهوية القومية.
تتناول قصة «العيد» تجربة خاصة وفريدة، حيث ترصد جانباً من مشاعر الاغتراب التي يعيشها بعض أبناء الجيل الجديد، الذين يحملون على أكتافهم مسئولية تحديث وتطوير مجتمعاتهم. نقول تجربة خاصة لأنها تعبّر عن مشكلات لا يعانيها سوى أبناء هذا الجيل الأحدث، الذي يخوض تجربة السفر إلى الخارج من أجل الحصول على المستويات الأعلى من العلم الغربي، إنهم يشعرون بأهمية وقيمة ما يفعلون، غير أنهم يتعرضون لحالات الاغتصاب النفسي التي تفرضها تجربة الاغتراب، والطبيعة المغايرة لمجتمعات لا يتواءمون معها، لتعبر عن حدة الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، وتزداد حدة هذا الصراع من خلال وعيهم بحتمية هذا التوائم الذي يؤدي إلى اكتساب سلوكيات وأنماط جديدة للحياة، تتصادم بالضرورة مع ما اعتادوه في مجتمعاتهم وربما تزيح كثيراً من القيم التي تمنح الشرقي خصوصيته.
تختار «هدى النعيمي» لحظتها القصصية ببراعة، لتكون أكثر هذه اللحظات تعبيراً عن المعاناة، حيث اختارت صباح أول أيام العيد، وهي لحظة تحتشد بكثير من العادات والتقاليد والشعائر والممارسات شديدة الخصوصية والارتباط بالبيئة المجتمعية، فتكون هذه اللحظة هي أحد طرفي المفارقة، ويكون الطرف الآخر هو المكان الذي تستقبل فيه الراوية لحظة العيد، حيث تستقبله في إحدى مدن الجنوب الفرنسي وهناك لاشيء غير ورقة التقويم تشير إلى العيد: “الشوارع كما هي، الجدران هي نفس البرودة، ونفس الهدوء القاتل، تكبيرات المصلين لا تأتي من المساجد الكبيرة، رائحة الطعام لا تعبق المكان، هكذا تختزل هوية العيد في مجرد رقم دال على اليوم في ورقة ملتصقة بروزنامة مثبتة على حائط صامت في مكان تقول عنه (مكان إقامتي المؤقتة) ويعني هذا أن الحياة تظل مؤجلة، ومرهونة بالعودة للوطن .
ومن الطبيعي أن لحظة كهذه تثير مشاعر الحنين وأوجاع الاغتراب، هكذا تبدأ الذات في تأمل موقفها ومراجعة حساباتها، هكذا تبدأ في طرح الأسئلة: ” توقعت أن أسمع تكبيرات المصلين من الجامع، وأن أشم رائحة الطعام المجهز لهذا اليوم.. لا شيء من ذلك .. ترى لماذا ؟.. كل شيء كعادته كل يوم.. الوجوه.. الأبعاد.. الاتجاهات. أين العيد إذن، أين عباءتك التي كنت اختبئ تحتها أنا وأخوتي ونحن صغار؟»
تحفل القصة بكثير من الأسئلة على هذا النحو، حتى تصل إلى السؤال الوجودي الصعب: ” أشعر بالحنق… لم كل هذا؟ لم أنا بعيدة عن الديار.. عن الأهل.. عن العيد نفسه.. ماذا جئت أفعل في هذه المدينة النائية عن ذاتي في هذا اليوم.. هل يستحق ما جئت له فعلاً ما أنا فيه؟!.. يا الله !! »
ويبدو لي أن هذه الأسئلة الأخيرة، هي أهم وأخطر ما يطرحه هذا النص حيث تعبر لا عن أزمة الشرقي المغترب فقط، وإنما تعبر عن أزمة إنسان ما بعد الحداثة الذي بدأ مراجعة كل المفاهيم والقيم التي انتجتها لحظة حضارية سابقة، ومناقشة اليقينيات التي بدت دائما ثابتة وبراقة ليكتشف في النهاية إن الإنسان عليه أن يضحي بأبسط حقوقه الإنسانية من أجل معانٍ مجردة حول التفوق الحضاري، أن ضحية الصراعات الحضارية في نهاية الأمر هي الإنسان ذاته، الذي ينبغي عليه دائما أن يضحي بالخاص من أجل العام، حيث يصبح العام تعبيراً عن مطالب مجتمعية. هنا يصل الصراع النفسي لأعلى درجاته، ولا تنتظر من القضية أن تحسم نهائياً، لأن انحياز السارد للعام يعني قتلاً للمشاعر الإنسانية وطمساً لفكرة الخصوصية التي يلح عليها منذ البداية، كما أن انحيازه للخاص يعني في المقابل التخلي عن دور الفرد تجاه مجتمعه، وهي قيمة ما زالت تلقى صدى في المجتمعات النامية التي بسبيلها إلى التطور، هذا الموقف البسيط، موقف الذات والآخر – الذي نمارسه يوميا دون أن ندري- يصبح موقفاً وجودياً في قصة من أفضل قصص المجموعة، وتتضح أزمة الراوية وصعوبة موقفها في الاستغاثة التي تطلقها في نهاية المقطع مشيرة إلى عجزها عن حسم الموقف وإحالة الأمر كله لله (يا الله!!).
يتأكد البعد الاجتماعي وما ينشأ عنه من صراعات نفسية في قصص «هدى النعيمي» ليصور حدة الأزمة، واحتدام الصراع الإنساني في مرحلة جديدة من الوعي الاجتماعي تقع في لحظة تاريخية، تتسم بالتغير والتطور الدائبين، واختلاف كثير من المفاهيم والممارسات التي كانت سائدة ثم أصبحت في حاجة إلى تغيير، ويقف إنسان هذه المرحلة موقف الحائر بين مفردات وعي مستقر غرسه الآباء والأجداد، وبين متطلبات وعي جديد مُنتج عن التغير الهائل في كل شيء، حتى في طبيعة العلاقات الإنسانية، وهذا الموقف الحائر هو ما يدعو الكاتبة – في جل قصصها – إلى أن تتأمل الظواهر الاجتماعية وإخضاعها للتحليل.
في قصة (علاقات) ترصد الكاتبة لمجموعة من العلاقات الإنسانية التي تحيط بها مثل: علاقات الأخوة والصداقة والأبوة والجيرة، وأيضاً العلاقات العاطفية حيث تقوم قصة حب غير مكتملة بدور الحاضر الغائب طوال النص. وكالعادة فان «هدى النعيمي» تقدم لنصوصها بمقطع يعلن عن مناسبته للنص والزمان والمكان، يبدأ هنا من صباح يوم ذكرى ميلاد بطلة القصة، التي تبدأ بطقوس الاستعداد للاحتفال بهذه الذكرى في المساء، وأثناء ذلك تتكشف العلاقات واحدة تلو الأخرى، بمشاعر مختلفة : الحب والحنان والصداقة من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات والهدايا، حتى الأخوة المغتربون لا تفوتهم المناسبة لمد مساحة من التواصل مع الآخرين، غير أنها تصبح مجرد تعبيرات هاتفية سريعة ومبتسرة، لا تترك أثراً حميماً في النفس كما سوف نرى، غير أن بطلة القصة تظل طوال الوقت في انتظار مهاتفة لا تجيء من الحبيب الذي تقصيه الغربة، فتقلص وجوده في ضميرها عاماً بعد عامٍ. وعلى الرغم من توقعها بأنها ستكون مهاتفة روتينية مثل كل عام إلا أنها كانت في حاجة إليها، فقط لتثبّت يقينها بقيمة الحب بوصفه من أرقى وأهم العلاقات الإنسانية في تاريخ البشرية، إنها مازالت في حاجة إلى سماع صوته وهو يقول: ” في العام القادم نكون معا يا حبيبتي” لكن المهاتفة لا تأتي أبداً. يحدث هذا في نفس الوقت الذي يتقدم فيه شاب لخطبة ابنتها، ليكون ذلك بداية إلى علاقة زوجية جديدة، في مقابل علاقة قديمة تنحل وتنهار تلقائياً.
هذه المقابلة بين حب يموت وآخر يولد، توقظ في وعي بطلة القصة حالة من الصراع الداخلي، ولكنها تحسمه بالموافقة على عريس ابنتها. تفعل هذا بنوع من الاستسلام لواقع يتكرر على نحو عبثي، يؤكد مصير الأنثى في كل زمان ومكان. تصل لهذا اليقين وهي تقرأ في جريدة مقالاً بعنوان (علاقات) يؤكد المقال على أن العلاقات بين البشر تحتاج رعاية الطرفين لتبدو أشبه بنبتة تنمو وتورق وتثمر بالرعاية المستمرة. يأتي المقال بوصفه مقابلة جديدة، تعمق إحساسها بعبثية الواقع، وتستدعي في ذاكرتها علاقة تتفكك بين الأم وابنها الغائب لسنوات فتقول: “نظرت لوجه أمي.. ما عادت الدمعات تلمع في عينيها عند سماع صوت أخي أو سماع أخباره، في آخر زياراته للأسرة كان طفله الأول يحاول المشي، قال لأمي وهو يغادر سأعود به العام المقبل وهو يجري كالعفريت، لكننا لم نره بعدها، ولا رأينا عفاريته ثانياً.
وإذا كان الاغتراب يؤدي إلى تحلل العلاقات الإنسانية كما في قصة (علاقات) أو يؤدي إلى تشذي الذات كما في قصة (العيد) فان الكاتبة تقلّب فكرة الاغتراب على كل وجه لتختبرها في مواقف مختلفة، حتى أن كل نص من نصوص المجموعة القصصية، يمهد أو يستعرض صوراً من تفكك العلاقات الإنسانية، فنجد في قصة (المكحلة) إحالة إلى أن الاغتراب هو بداية الطريق إلى الخيانة التي تبدأ بخيانة الفرد لذاته ثم تنتهي بخيانته لمجتمعه. وهكذا تكشف قصة (المكحلة) عن تطور الوعي بفكرة الاغتراب، بمعنى أن وحدات السرد في هذه النصوص ليست منفصلة عن بعضها البعض، بقدر ما تمثل بنية كلية تنشأ عن علاقات متشابكة وعميقة بين كل الوحدات السردية، بما يؤكد وعي الكاتبة بأهمية التوظيف التقني، وبما يعني أن الوحدات السردية لا تتوقف عند سرد الحكايات، بل تستدعي نسقاً للتفكير، فتبدو المكحلة رمزاً للهوية العربية ومرادفاً للذات الجمعية الأصيلة. تأتي المكحلة هنا ليس باعتبارها أداة للزينة، بل رمزا للحظة تنوير تشرق في نهاية المجموعة القصصية، عندما يوقفنا السرد على أن الذات في لحظات اغترابها تكون عرضة للاستلاب والضياع. الاغتراب هو ما أدى إلى وقوع الزوج في براثن المرأة الأجنبية، أسرته، كما أسرت السيرانات أوديسيوس في متاهته، أغوته بشعرها الأشقر، ولسانها المعوج:
” كيف استطاعت أن تسلب منك – يا سيد الكبرياء – جدائل الفرح التي اسكُنها، وواحات الدفء التي استظل بها من لهيب اغترابي، كيف استطاعت عيناها الزرقاوان أن تسرقا الكحل من عيني، وتلقي بالمكحلة في أعماق النهر البارد؟)
هكذا ينتهي السرد إلى موقف آخر غير موقف التفكك الذي رأيناه في العلاقة بين الأم والابن في قصة (علاقات) إلى موقف التخلي والانزياح في الآخر الأجنبي، وهكذا لا تجد الزوجة امامها غير ملاذها الاخير المتمثل صراحة في صورة الأم / الوطن فتقول:
«اشتاق إلى وجهك يا أمي.. اشتاق إلى وجهك يا وطني، اغفر لي فلست فوق الخطأ، ولست فوق الزلل .. سأعود إليك يا أمي.. ولكن بدون المكحلة». العودة بدون المكحلة تشير إلى ما يحدث من تغير في الغربة، فمرارة التجربة تعلق بنا وتترك فينا ندوبا وجراحا لهذا فلن نعود من اغترابنا بنفس ذواتنا القديمة، وهكذا يصل وعي (هدى النعيمي) بمعنى الاغتراب إلى ذروته، وهكذا يبدو لحن الاغتراب أحد أهم علامات المجموعة القصصية، ومن خلاله يتغير موقع الذات بعداً أو قرباً من مركزها . فيما يظل الآخر في موقعه هناك، وبعيداً عن الذات