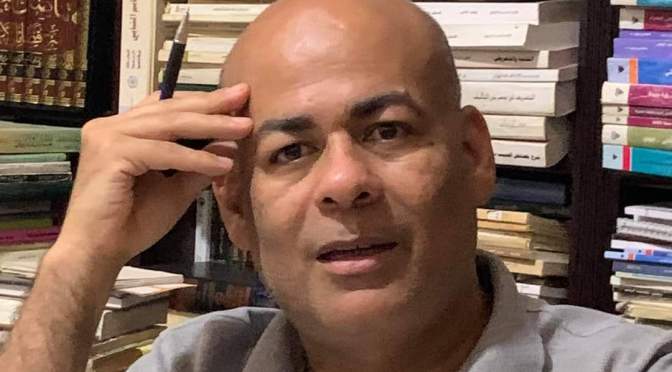محطات للوصول.. سيراً على الأقدام
لكم تساءلت: لماذا جاء ميلادى بالقرن من ساحة الحرب؟.
بسذاجة لم تكن هى التهور بعينه ،زعمت أننى جئت لأستل قلمى من بين الضلوع، لكى أطفئ لهيب المعارك فداست كلماتى على مواقع فى حياتى أحدثت إنفجارا أشبه ما يكون بدوى معارك الحرب العالمية الثانية!!.
لنعد إلى النشأة…
ولدت فى مدينة المنصورة يوم 21/3/1938 على إيقاع دبيب الراكضين فى هلع عبر الحوارى كانوا يحذرون الأهالى من اشعال أي عود ثقاب، صيحات قلقة، ملحة فى طلب نشر عباءة الظلام كدعوة صريحة للحفاظ على الأرواح من خطر الموت، بعد أن تقدمت جيوش المحور من “العلمين” وقاست بأس الألاف من جنود بريطانيا العظمى التى كانت تضع مصر تحت ما تسميه بالحماية.
أدركت مبكراً أننى لم أعتد على أحد حتى يرغمنى على ملء عينى بأشباح الظلام منذ طفولتى منة يدخلنى فى أثواب، هل يستطيع الإدعاء بأن ليل هذه الطفولة كان باسم القسمات؟
من يمكنه الزعم بأن البسماء كانت على ايقاع ذلك الواقع تضحك لى؟.
من رابع الامستحيل أن أضع توصيفاً خارج جغرافيا المكان، خاصة وأن من هم على شاكلتى لا يستطيع أحد منهم أن يصبح ذاتا مستقلة عن واقعها، وما أعرفه أنه إذا كانت هناك خصوصية في الثقافة فإن ذلك لا ينفى وجود الملامح المؤثرة فى عدد من الثقافات الأخرى، وهى التى تحفز فى الذات أوتاداً من نسخ الإنسانية، وعبير الروح.
ولكنى لا نبتعد عن المواد الخارجية التى ساهمت فى تكوينى.
أقول: ولدت لأب كان يعمل حدادا بورش السكك الحديدية، إمتلأ سمعى بقعقعة عجلات القطارات فى ذهابها وإيابها بالقرب من البيت التى ولدت فيه.
مشكلتى المبكره مع هذه القطارات أنها لم تنقطع عن أدوار الوصول ـ فى مختلف الأوقات ـ إلى بلاد لا أعرف إلى متى سأظل جاهلاً لمدن يعينها الله عند إقبال الصبح فيرتمى لملكوت السموات والأرض.
القطارات التى كانت تسير بقوة اشتعال الفحم وضغط البخار أغوتنى بالذهاب معها إلى مواقيت الشمس ، أى قطار ـ بعد ذلك ـ يخرج من المحطة كان مطاردا منى، ومن أصحابى، مرات ومرات، كنا نتراهن على الدخول معه فى سباق ، نراقبه عندما يلوح قادما من بعيد بصدره المنتفخ بالسواد.. من يفوز.. نحن أم القطار.
كم من المرات سبقناه .. كم مرة ضحكنا فيها على فشله ؟ فى زهو الفائزين وقفنا ـ على مسافة قصيرة منه ـ فى تحد .. كان يقبل ناحيتنا فى تهافت مثل دودة عجوز، وعندما يقترب نروح نعيد المسافة من بعيد، إذا لم يكن فى حياتنا شئ يبعث على السرور سوى اللعب مع القطارات والدخول معها فى سباق كانت نتائجه تأتى دائماً لصالحنا .
تحت عمود النور ـ (نقطة تجمعنا) ـ استعدنا مرارا خيبته حتى أفعمنا الإنتصار بنوع من الاعتداد بالنفس، ومن حيث لا أعلم أجدنى ـ فجأة ـ غير مبسوط، غير مبتهج، شارد الذهن، إنه يصل إلى بلاد لا نعرف شيئاً عنها، أما أنا لا عمل لى سوى إراقة الوقت فى استعادة ضحكة صارت لامعنى لها .
لمحناه قادماً من بعيد كأنه إنسان يمشى فى عرج .. صعد ثلاثة من أصدقائى إللى سلم العربة الثالثة .. كانت عربة السبنسة قريبة منى .. صعدت إليها .. نزل أصدقائى الواحد منهم تلو الآخر فى تهليل وفرح .. عندما حاولت أن أنزل مثلهم وجدتنى منطرحاً على ظهرى بعد أن داست آخر عجلة من عربة السبنسة على ذراعى اليمنى .
أول رصيف على شمال المحطة :
كأن القطار (وهو يمثل الزمن المتحرك) أراد أن يثأر منى، أن يعيد إلى نفسه شيئاً من الإعتبار ، أرانى كيف تكون نهاية الضحك عليه، لم يعد من المعقول أن يفكر مبتور الذراع فى التحليق أو التفكير فى الذهاب إلى المدن التى يصل إليها القطار، الأب والأم والأقارب رجحوا كفة عدم صلاحيتى للقيام بأى عمل، قال: أبى لن ينجيه من الغرق إلا القرآن، انتظمت فى صفوف مدرسة المحافظة على القرآن الكريم .
دونما إدراك منى ـ آنذاك ـ لكينونة المكان ومدى تأثيره فى الشخصية، أذكر أن المدرسة كانت تقع بين مبنى “جماعة الإخوان المسلمين” و”حزب مصر الفتاة” لكى أذهب إليها لابد أن أمشى من أمام الحزب الذى كان يشغل الطابق الأرضى من عمارة لا تزال حتى اليوم تتمتع بشكلها الهندسى الجميل .
أثناء المرور من أمامها كان يسترعى انتباهى لفيف من الشباب كأنهم جماعة فى خلية نحل لا يحكمها سوى الحركة المستمرة داخل الصالة المطلة على الشارع، كنت أحسدهم لأنهم لم يتذوقوا ـ مثلى ـ الآم عصا الشيخ إبراهيم عبادة بسبب عدم حفظ اللوح المقرر والذى ينتهى عند الآية التى قال فيها فرعون للنبى موسى عليه السلام “ألم نربِّك فينا وليدا ولبثت فينا من عُمرك سنينَ ؟!”.
حتى ولو ظل جرس المدرسة يرن فى غلاثة ـ كأنه ينادى على أنا بالذات ـ كنت أوهم نفسى ونفسى تقبل التصديق أن هذا ليس جرس المدرسة، لكنه جرس كنيسة الملاك الواقعة وراء المدرسة فى السكة الجديد .
فعلت مثل الذين كانموا هناك، سددت نظراتى إللى صفحات جريدة الحزب المفرودة على الجدران دون أن أعرف تناقضات الحركتين ـ الإخوان المسلمين، وحزب مصر الفتاة ـ فى المنطلق والعقيدة، كنت لا أعرف أن جماعة الإخوان المسلمين نمت جذورها من الدين الإسلامى، وحزب مصر الفتاة بأصوله من الحضارة الفرعونية ، الشئ المؤكد، وما شفته بعينى أن الرابطة التى تجمع بين الإخوان المسلمين كانت قوية، وتظل تتصاعد وهى تستمد حقها فى الوجود بقوة الدين.
أيام الهروب من عصا الشيخ إبراهيم عبادة لم يخطف بصرى، ويلهب مشاعرى إلا حركة شباب حزب مصر الفتاة، حين كان يرتفع بينهم صوت يستقر الجميع لكى يحتشدوا ويخرجون في مظاهرة، وبمجرد أن ترتفع عقيرتهم بالثورة والتنديد بأعمال الحكومة كانت الدكاكين والورش الأهلية تغلق أبوابها، ويسير صبية الورش والأسطوات مع الجموع حتى تنقلب شوارع المنصورة ـ من شدة الزئير ـ إلى وحش ضارى.
يعتلى شاب الأعناق، يلوح بقمص أبيض مضرجا بدماء طالب خرج فى مظاهرة أمس، أردته إدى الرصاصات قتيلا،كانت البندقية صناعة انجليزية، الرصاصة انجليزبة، اليد التى ضغطت على الزناد مصرية!؟.
تسألت فى سن النضوج : أمن الحكمة أن يموت الشجاع ويعيش الجبان ؟، ثم هل كان من الحكمة أن يعيش كيفما كانت الحياة، أم يظل يخضون أهوال لا الصراع ؟ من كان محمولا على الأعناق راح يهتف والمتظاهرون يرددون وراءه (جبل الطور اليوم بينادى .. ألقوا فىَّ عبد الهادى).
عرفت لأول مرة أن فى مصر حكومة موالية للإنجليز، وأن رئيس وزراؤها كان يدعى إبراهيم عبد الهادى باشا، وأنه أمر باعتقال من يخرجون على التظاهر وإلقائهم فى معتقل “جبل الطور”.
تحول هروبى من المدرسة إلى متعة سياسية وثقافية، أصبح الشارع صديقى ومعلمى قبل الكتاب، وحتى بعد أن عرفت حياة الكتب كان هو المورد الأول للمعرفة، كما أذكر له بالإمتنان والشكر سعة صدره لى حين استضافنى على إحدى التلتورات ومنحنى شرف الكتابة بين أسطوات دهان السيارات وميكانيكية على الطريق وأصحاب ورش متنقلة للسمكرة وضبط وإصلاح أبواب العربات .
هناك كتبت رواية “أولا المنصورة”، وكنت كلما فرغت من فصل رحت أقرأه عليهم، وكنت أشجعهم، بل وأرجوهم أن يقولوا لى رأيهم بلا حرج أو تحفظ، ولكم استمتعت إلى تعليقاتهم ـ فى حب ـ كتلميذ يتلقى درجات النجاح من معلمه(1).
العودة إلى خط فرعى فى محطة مؤقتة:
ذكرتنى أجواء مظاهرات الطلبة والعمال بتلك الأجواء التى كانت تسود البلاد فى عباءة من الظلام أبان الحرب العالمية الثانية، فى ذلك الوقت كنت فى سن المراهقة العمرية والفكرية، تمنيت أن أعود من تحليقاتى فأجد فى طريقى مخرجا سينمائيا له عشق بالشوارع مثلى، وأن يعهد إلىَّ بدور قريب الشبه من دور ممثل فيلم”سارق الدراجات”الإيطالى، طقت فى دماغى حكاية التمثيل بعد أن شاهدت “سفير جهنم” ليوسف بك وهبى، و”عودة الغائب” لأحمد جلال، و”ابن الفلاح” لمحمد الكحلاوى، و”أحمر شفايف” لنجيب الريحانى .
فى ذلك الوقت، اعتاد أبى أن يشترى يوم الخميس مجلة “المصور” بأربعة قروش، وكان يطلب إلىَّ أن أقرأها على سمعه، كان أول عدد اشتراه يحمل غلافة صورة البطل “عبد القادر طه” الضبع الأسود الذى قاتل اليهود فى بسالة وشجاعة حتى حاصروه فى معركة “الفالوجا” تابعت القراءة بعقل يسرح مع ميعاد صديقى رئيس فريق التمثيل بمدرسة الصنايع، كان دعانى فى نهاية العم الدراسى لمشاهدة العروض المسرحية التى كانت تجرى فى مسابقة فنية بين فرق المدارس المسرحية على مسرح الجامعة الشعبية “الثقافة الجماهيرية الآن”، كدت أقبل يده حتى يجد لى دوراً، أى دور، وقفت أمامه أرتجل بعض المشاهد من أفلام شاهدتها، كان ينظر إلى فى رثاء، حول جاهدا ألا يخدش مشاعري، وهو جالس وراء مكتبه فى الغرفة التى خصصها أبوه له ليمارس فيها هوايته.
لمحت على مكتبه مسرحيات لموليير، وأحمد شوقى،وبرناردشو، وتوفيق الحكيم، أعارنى هذه الأعمال قرأت بدون فهم أو استساغة، أكتشف أن القراءة تحتاج إلى تربية وجهد ومعناه، ولكن بالتدريب عليها يمكن للمرء أن يحصل على نوع من الإبتكار، ولكن كنت أتعجل الدور الذى سيرفعنى إلى قمة نجيب الريحانى.
باغتنى صديقى المسرحى بقوله والحرج يتملكه : ليس الفن تمثيلاً فقط، أبواب الفنون كثيرة، ممكن ترسم، ممكن تكتب مسرحيات، ممكن روايات … قصص …..، أذكر أنه قال: ونظراً لأن التمثيل بالذات يحتاج لمواصفات جسدية محددة، تحرج أن يقول بأننى بذراع واحدة، ثم استطرد : إنما يمكنك أن تقرأ، فالقراءة إبداع آخر، عندما تتذوق جمالياتها ستكون قد غرزت فى نفسك مجموعة من الفضائل، وقد يمكنك أن تعيد صياغتها وتقديمها فى أنماط تكون ملائمة فى التعبير عن هموم الإنسان المعاصر، وبذلك تتيح السيادة للأسلوب القادر على معالجة أدق خلجات الإنسان وخلجات اللحظة المعاشة بتناقضها.
ثم أعطانى مجموعة من الروايات الرومانسية :”بول وفرجينى”، “غادة الكاميليا”،”تحت ظلال الزيزفون”، وجميعها لفظته خشونة حياتى وتربيتى التى كان فيها الكثير من الصرامة، لكننى انطويت على الكتب التى اخترتها بنفسى.
أثناء البحث عن مايشبع جوعى الثقافى، عثرت على سلسلة “قصص للجميع”، و”كتب للجميع”، على صفحاتها طالعت “ذئاب جائعة” لمحمود البدوى، توقفت طويلاً عند “دماء لا تجف” لعبد الرحمن الخميسى، دفعنى حبى له للبحث عن مؤلفاته، انسكبت فى روحى قطرات من دماء مجموعته القصصية “قمصان الدم”، ثم تعرفت على عبد الرحمن الشرقاوى قبل أن تتسع أمامى شرفة المطالعة؛ فتعرفت على بلزاك وموباسان وديكنز وشالوخوف وجوركى وتولستوى وتشيكوف.
فى “دعاء الكروان” استوقفنى وصف طه حسين لحياة “آمنة” بطلة روايته بأنها “كلها شظف وخشونة”، وفى رواية “زينب” لمحمد حسين هيكل وصف تقريرى لحياة الفلاحين الذين ـ فى خنوعهم ـ تكيفوا مع حياة الشقاء، وباتوا قانعين بما يقع عليهم، ويرضون عنه.
عرفت المجتمع بأفراحه، بأتراحه، بطبقاته المستبدة، بفلسفاته الإجتماعية من الروايات، و القصص، مع أننى كنت أحد الأضلاع الرئيسية فى طابور التلاميذ الخائبين الذى كان أول من ترتفع على قدميه وتهبط عصا الشيخ إبراهيم عباده، فى عز “طوبه وأمشير”.
بيد أن ذلك كله لا ينسى وجه الطالب محمد حسن عبد الله الذى أصبح أستاذاً للأدب الحديث فى جامعة الكويت، ثم فى جامعة القاهرة، كان قد سبقنى إلى المعهد الدينى بالمنصورة عام 1950 ـ 1951، وفى أحد الأيام جاء لزيارة المدرسة فى زيه الأزهرى سألته عن طريق القبول بالأزهر، عرفت منه تاريخ تقديم الأوراق، فى يوم الامتحان جلست أما ثلاثة من الشيوخ، طلب إلى أحدهم أن أكمل مابعد :”محمد رسول الله والذين أمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم”، وطلب الثانى أن أكمل مابعد: “إنا نحن نحيى الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شئ أحصيناه فى كتاب مبين”، وطلب الثالث أن أكمل ما بعد: “يا معشر الإنس والجن ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذو إلا بسلطان”.
تعثرت فى التلاوة لأول مرة تفصد العرق من جبهتى، أغرق عينى فى بحور الخوف والتعلثم: يا معشر .. يا معشر، والشيوخ الثلاثة يشجعوننى قائلين فى نفس واحد : هه .. فأقول: يا معشر الجن، وهم مازالوا يشجعوننى بكلمة: هه، لعلى أنطق وأقول: يا معشر الجن والإنس، ثم انفجرت فى البكاء خوفا من الرسوب والعودة إلى محطات الهروب من المدرسة.
لكننى فوجئت بأحدهم يقول لى: قم يا شيخ عبد الفتاح أنت ناجح، وأوصانى ثلاثتهم بالآنكباب على تلاوة القرآن كل يوم حتى أحفظة عن ظهر قلب، ثم سألنى أحدهم قبل أن أغادر المكان، وهو سجل اسمى فى كشف الناجحين عن المذهب الفقهى الذى أريد أن أتلقى علومه، أجبت دون أن أعرف أوجه الآختلاف الفقهية فى الإسلام :المذهب المالكى، بص الشيوخ إلى بعضهم فى دهشة، ثم ابتسموا فى غموض حين سألنى أحدهم: أنت أصل جدودك مصريين؟.
لم أكن أعرف أن المذهب المالكى كان منتشرا فى مصر أبان عهد أحمد بن طولون حين كان الشيعة يحكمون مصر، وبسقوط حكمهم أصبح المذهب الشافعى هو السائد.
بعد أن حصلت على شهتدة الإبتدائية الأزهرية سنة 1955 إلتقيت بصديقى الميكانيكى تحدثت عن فكرة الألوهية والأجرام السماوية وهندسة بناء الكون، أعطانى كتاب”أسس الدولة” لجون ستيوارت مل، وأعمالا لهارولدلاسكى، كان يمشى وفى جيب جاكتته الأنجيل، وفى الآخر القرآن، وفى الجيب الداخلى”أصل العائلة” لأنجلز، هو من أساتذتى الأوائل الذين كنت أجلس معهم على التلتوارات، وعدنى بأن سيأتينى بمجموعة مكسيم جوركى القصصية”الحضيض”و”مخلوقات كانت رجالا”.
أكتشفت أن الكتابة هى المؤامرة الوحيدة الشريفة فى العالم ضد من يكيدون لللإنسان فعلمتنى الخبرة المكتسبة من الحياة، والثقافة أن أحرر لغتى من الأساليب المطروحة، أزعم أننى طبقت هذه التقنية أثناء كتابة “أولاد المنصورة”، اهتممت بالتركيز على الجانب الحركى داخل حى شعبى مهمش، أعلن لفيف من أبنائه عن عزمهم الخروج من نطاق الفردية بالمشاركة فى تكوين فريق لكرة القدم.
انتصروا على مختلف الصعوبات حتى تكوَّن الفريق،خاضوا به العديد من المباريات ضد فرق البلدان والقرى المجاورة، حين يعدون إلى الحى مفعمين بنشوة الفوز، كانوا بعيدين عن روح الأثرة والأنانية فيهدون فوزهم للمدينة التى لم تعرف الانتصارات وهى على ما يبدوا ـ فى ذات الوقت ـ لا تعرف شيئاً عنهم.
الصعوبة التى قابلتنى أثناء كتابة هذه الرواية ظهرت حين كنت أفكر: كيف أجعل الآخرين ـ بعد وقوع النكسة ـ يستمرون فى حركة تصاعدية، بينما كان على الطرف الآخر من يفشون ثقافة الهزيمة، والانكماش فى مواقع الفشل، وتكتمل فصول المأساة عندما نرى أن شباب الحى مستبعدون من كل تشكيل اجتماعى، لقد كونوا فريقاً لا يعرف غير الحصول على نتائج الانتصارات، ولكن أحد لم يستطع أن يشكل نهم قواما اجتماعيا، تتحقق على يديه ـ أو قدميه! ـ طفرة تنتشل من هم على حافة الإنهيار من الإنهيار .
لم يكن من نصيبهم سوى العيش فى حلة من ردود الأفعال المحبطة، وهى أعمال تعجزهم تماماً عن رد القهر؛ فاستعانوا على الوقوف أمامه بالحبوب المخدرة، ونسج الحلم التى يختلط فيها الكابوسى بالواقع، بينما كانت الشوارع تغرق فى أقوال ساسة لا يخلو أحدهم من ديماجوجية، تقول ما لا تفعل، وتفعل فى النور والظلام ما لا تعلن(!!).
ثم أتذكر ـ أثناء الكتابة ـ الزقاق التى انطلقت منه أعمال نجيب محفوظ لتناقش الكثير من قضايا الوطن وهموم المثقفين دون أن يبتعد الكاتب عن هذا السياج ليشارك فى حركة النضال السياسى؛ فقضيته الكبرى كانت الكتابة فقط والاهتمام بحياته الوظيفية، على حين كانت الحرية ـ منذ 1939 حتى 1944 ـ هى قضية البلاد الأساسية، وبحيث لم يهد لمجتمع المثقفين دور مؤثر، أو ضمير يحفز القوى المقهورة للوقوف على الأقدام فى صلابة .
حول عناصر البناء فى قصصى القصيرة، أنها فى جملة قصيرة ترهص بأنهيار الفواصل بين الشكل والمضمون :”وأحياناً باحتفاظ كل عنصر تقنى بخصائصه الموضوعية والجمالية ف إطار اندماج الفواصل بينها (2) .
لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لتجربتى الروائية أثناء كتابة روايتى” العنف السرى” لقد انتقلت بلين الروافد الإجتماعية المستمدة من جذور تاريخنا القومى، الفرعونى، القبطى، الإسلامى، لكى أنفخ فى روح عاطفة الإنتماء، وجدت حرية الفرد لا تتحقق فى مجتمع مكبل برزاءل الإستئثار والأنانية .
تابعت خطوات بطل الرواية، كان هو الذى يسوقنى مع كل تجربة يخوضها حتى تنتهى بالفشل، ومع ذلك ظل يحاول، بوجه آخر، واسم آخر، فى أمكنة مختلفة، ولقد تعدد فيه الأدوار ، فهو”المعصوب العينين” الذى يرى ببصيرته كل ما يدور فى “الخلاء” والخلاء فى الرواية هو البديل، أو المعادل الموضوعى للمدينة الفارغة من معانى الفضيلة.
بعد أن استكملت ملامح هذا البطل تسألت:هل يمكن أن يكون شاهدا على عصر ردئ؟.
إنه البطل العربى الذى نجده فى السجين بملامح “فهيم المصراتى”، وهو”الجندى” العائد من معارك الهزائم، وهو سلمان “الفران”، وهو “الشيخ” ثم “الإمام” الذى كان يقف على رأس حلقة الذاكرين مساء كل خميس “مستهلاً الإنشاد بالصلاة على النبى وآل بيته”، والترحم على الشهيد الإمام على ووللديه الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء (3) .
لقد شجعنى هذا البطل ـ كمنتقم لا يفتقر إلى بناء عقائدى، على أن أتحمل معه تبعات كل شخصية تولى القيام بها، ومضيت معه وهو يحول فى أجواء بلا فواصل، حيث تداعت جدران الأزمنة والأمكنة، حيث باتت تنتظمهما حلقة فى سلسلة من الشقاء، بين هو مستمر مع تقدم خطواته “فتسلمه الجدران إلى جدران أخرى لا نهاية لها (4).
هوامش: هذه الشهادة ضمن فعاليات مؤتمر السرد الجديد بمرسى مطروح 2008، رئيس المؤتمر خيري شلبي، والأمين للمؤتمر سيد الوكيل
………………………………………………………………………………………………………..
1. فازت الرواية بالجائزة الأولى فى المسابقة التى ينظمها نادى القصة .
2. بطل قصتى “بصقات فرعون الملونة” المنشورة بجريدة القبس الكويتية عام 1980 .
3. د.محمد زيدان “نصوص تسبح فى ملكوت الحلم” تأويلات لنماذج مختارة للقاص عبد الفتاح الجمل .
4. رواية “العنف السرى” المجلس الأعلى للثقافة 2007 ص 68.
5. المصدر السابق ص 126.
عودة إلى الفهرس